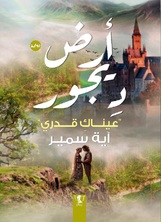عشيقات الطفولة
تاريخ النشر:
٢٠١٢
تصنيف الكتاب:
الناشر:
عدد الصفحات:
١٢٩ صفحة
الصّيغة:
٣٠٠
شراء
نبذة عن الكتاب
لا أعرف كيف اخترقنى سهم الحب بهذا العنف الهادر وأنا عيل مطلعش فعلا من البيضة، ولا يعرف – حقا – الفارق بين الألف وكوز الدرة؟ كيف تحولت بقدرة قادر إلى سمكة بلطى تخرج من بحر البراءة وقد علقت السنارة بفمها الصغير فيأتلق لونها الفضى فى أشعة الشمس قبل أن يُرمى بها على قطعة من الصاج المحمى وتُشوى وهى لا تزال حية على نار الغرام الموقدة.
كنت يادوبك أبلغ من العمر ست سنوات. نحيلا مثل الحديدة التى تحرك بها أمى أرغفة الخبز المرحرح. مرتاح البال لا يؤرقنى شئ فى الوجود سوى الإمساك بواحدة من تلك الفراشات المراوغة التى لا أكف عن مطاردتها فى غيطان البرسيم.
ولا يهمنى أن يعاملنى الوطن مثل القطط التى تأكل وتنكر، فقد ولدت عام 1973، شهر أكتوبر، والأنأح فى السادس منه، وتحديدا الواحدة ظهراً، وبعد 60 دقيقة من مولدى الميمون كانت قد حانت ساعة الصفر. وانطلقت طائراتنا الحربية، وزغردت السماء مثل زوجة رأت شراع بعلها ينتصب بعد ست سنوات من نكسة «الارتخاء»، والمثل يقول: خدوا فالكم من عيالكم، لكنى «دولة العلم والإيمان» لم تأخذ فالها ولا بالها، لم تنتبه لى، تركتنى – أنا وش السعد والهنا - أذهب إلى المدرسة مرتديا شبشب زنوبة وبيجامة من الكستور يحصل عليها أبى من متاجر «الكساء الشعبى». تقتادنى أختى التى تكبرنى بعامين ثلاثة إلى مقر العلم والتعليم كل صباح كما يقتاد عشماوى متهما يرتدى البدلة الحمراء إلى حبل المشنقة(*).
لم يكن ثقب الأوزون قد ظهر بعد، ولم تكن زيادة حرارة كوكب الأرض تحتل صدارة جدول الأعمال فى مؤتمرات البيئة الدولية، وبالتالى كان المناخ فى مصر لا يزال معتدلا ربيعاً، باردا شتاء، وكانت تيارات الهواء «الصاروخية» تصفع وجوهنا نحن ملائكة الله الصغار عبر زجاج الشبابيك المكسور فى فصول المدارس الحكومية.
ورغم أن هوجة الانفتاح كانت فى عزها إلا أن الدولة فى نهاية السبعينيات كانت لا تزال تشعر بالحد الأدنى من حمرة الخجل تجاه الفقراء الذين يشكلون الأغلبية العظمى من الشعب، ولم ترفع بعد الراية البيضاء فى مواجهة ضغوط السادة فى البنك الدولى الذين طالما أمروا برفع الدعم عن محدودى الدخل «هؤلاء الذين أصبحوا فى الألفية الثالثة معدومى الدخل والحمد لله فهدأت تلك الضغوط». المهم أن هذا الحد الأدنى من «حمرة الخجل» انعكس فيما كان يسمى «الوجبة المدرسية» والتى كانت تُوزع علينا يوميا وبالمجان، وهى عبارة عن رغيف ناشف مثل البلاستيك وقطعة كبيرة من جبنة المثلثات تشعر حين تتذوقها أنها مخلوطة – على نحو ما – بالتراب. ولم تكن تعنينا الوجبة فى حد ذاتها، فأمهاتنا لم يكن يثقن أبدا فى أى شئ يتعلق بالحكومة، وقبل أن نحشر كتبنا الكثيرة والثقيلة فى حقائبنا القماشية، كن يحشرن أولا عددا رهيبا من السندوتشات البيتى الشهية، وكأننا سنغيب عن البيت أياما وليس ساعات فى مدرسة لا تبعد سوى عدة دقائق سيرا على الأقدام، وبالتالى لم نكن نشعر بحاجتنا لهذه الوجبة من أجل مواجهة أى إحساس بالجوع، بل لمواجهة هذا الإحساس العارم بالملل!
كنت يادوبك أبلغ من العمر ست سنوات. نحيلا مثل الحديدة التى تحرك بها أمى أرغفة الخبز المرحرح. مرتاح البال لا يؤرقنى شئ فى الوجود سوى الإمساك بواحدة من تلك الفراشات المراوغة التى لا أكف عن مطاردتها فى غيطان البرسيم.
ولا يهمنى أن يعاملنى الوطن مثل القطط التى تأكل وتنكر، فقد ولدت عام 1973، شهر أكتوبر، والأنأح فى السادس منه، وتحديدا الواحدة ظهراً، وبعد 60 دقيقة من مولدى الميمون كانت قد حانت ساعة الصفر. وانطلقت طائراتنا الحربية، وزغردت السماء مثل زوجة رأت شراع بعلها ينتصب بعد ست سنوات من نكسة «الارتخاء»، والمثل يقول: خدوا فالكم من عيالكم، لكنى «دولة العلم والإيمان» لم تأخذ فالها ولا بالها، لم تنتبه لى، تركتنى – أنا وش السعد والهنا - أذهب إلى المدرسة مرتديا شبشب زنوبة وبيجامة من الكستور يحصل عليها أبى من متاجر «الكساء الشعبى». تقتادنى أختى التى تكبرنى بعامين ثلاثة إلى مقر العلم والتعليم كل صباح كما يقتاد عشماوى متهما يرتدى البدلة الحمراء إلى حبل المشنقة(*).
لم يكن ثقب الأوزون قد ظهر بعد، ولم تكن زيادة حرارة كوكب الأرض تحتل صدارة جدول الأعمال فى مؤتمرات البيئة الدولية، وبالتالى كان المناخ فى مصر لا يزال معتدلا ربيعاً، باردا شتاء، وكانت تيارات الهواء «الصاروخية» تصفع وجوهنا نحن ملائكة الله الصغار عبر زجاج الشبابيك المكسور فى فصول المدارس الحكومية.
ورغم أن هوجة الانفتاح كانت فى عزها إلا أن الدولة فى نهاية السبعينيات كانت لا تزال تشعر بالحد الأدنى من حمرة الخجل تجاه الفقراء الذين يشكلون الأغلبية العظمى من الشعب، ولم ترفع بعد الراية البيضاء فى مواجهة ضغوط السادة فى البنك الدولى الذين طالما أمروا برفع الدعم عن محدودى الدخل «هؤلاء الذين أصبحوا فى الألفية الثالثة معدومى الدخل والحمد لله فهدأت تلك الضغوط». المهم أن هذا الحد الأدنى من «حمرة الخجل» انعكس فيما كان يسمى «الوجبة المدرسية» والتى كانت تُوزع علينا يوميا وبالمجان، وهى عبارة عن رغيف ناشف مثل البلاستيك وقطعة كبيرة من جبنة المثلثات تشعر حين تتذوقها أنها مخلوطة – على نحو ما – بالتراب. ولم تكن تعنينا الوجبة فى حد ذاتها، فأمهاتنا لم يكن يثقن أبدا فى أى شئ يتعلق بالحكومة، وقبل أن نحشر كتبنا الكثيرة والثقيلة فى حقائبنا القماشية، كن يحشرن أولا عددا رهيبا من السندوتشات البيتى الشهية، وكأننا سنغيب عن البيت أياما وليس ساعات فى مدرسة لا تبعد سوى عدة دقائق سيرا على الأقدام، وبالتالى لم نكن نشعر بحاجتنا لهذه الوجبة من أجل مواجهة أى إحساس بالجوع، بل لمواجهة هذا الإحساس العارم بالملل!
إضافة تعليق
لم يتم العثور على نتائج